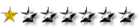فصل
روى مسلم في صحيحه : من حديث أبى الزبير ، عن جابر بن عبد الله ، عن النبي
صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : " لكل داء دواء ، فإذا أصيب دواء الداء ،
برأ بإذن الله عز وجل " .
وفي الصحيحين : عن عطاء ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء " .
وفي مسند الإمام أحمد : من حديث زياد بن علاقة ، عن أسامة بن شريك ، قال :
كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم ، وجاءت الأعراب ، فقالوا : يا رسول
الله ! أنتداوى ؟ فقال : " نعم يا عباد الله تداووا ، فإن الله عز وجل لم
يضع داء إلا وضع له شفاء غير داء واحد ، قالوا : ما هو ؟ قال : الهرم " .
وفي لفظ : " إن الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء ، علمه من علمه وجهله من جهله " .
وفي المسند : من حديث ابن مسعود يرفعه : " إن الله عز وجل لم ينزل داء إلا
أنزل له شفاء ، علمه من علمه ، وجهله من جهله " وفي المسند و السنن : عن
أبي خزامة ، قال : قلت : يا رسول الله ! أرأيت رقى نسترقيها ، ودواء
نتداوى به ، وتقاة نتقيها ، هل ترد من قدر الله شيئاً ؟ فقال : " هي من
قدر الله " .
فقد تضمنت هذه الأحاديث إثبات الأسباب والمسببات ، وإبطال قول من أنكرها ،
ويجوز أن يكون قوله : " لكل داء دواء " ، على عمومه حتى يتناول الأدواء
القاتلة ، والأدواء التي لا يمكن لطبيب أن يبرئها ، ويكون الله عز وجل قد
جعل لها أدوية تبرئها ، ولكن طوى علمها عن البشر ، ولم يجعل لهم إليه
سبيلاً ، لأنه لا علم للخلق إلا ما علمهم الله ، ولهذا علق النبي صلى الله
عليه وسلم الشفاء على مصادفة الدواء للداء ، فإنه لا شئ من المخلوقات إلا
له ضد ، وكل داء له ضد من الدواء يعالج بضده ، فعلق النبي صلى الله عليه
وسلم البرء بموافقة الداء للدواء ، وهذا قدر زائد على مجرد وجوده ، فإن
الدواء متى جاوز درجة الداء في الكيفية، أو زاد في الكمية على ما ينبغي ،
نقله إلى داء آخر ، ومتى قصر عنها لم يف بمقاومته ، وكان العلاج قاصراً ،
ومتى لم يقع المداوي على الدواء ، أو لم يقع الدواء على الداء ، لم يحصل
الشفاء ، ومتى لم يكن الزمان صالحاً لذلك الدواء ، لم ينفع ، ومتى كان
البدن غير قابل له ، أو القوة عاجزة عن حمله ، أو ثم مانع يمنع من تأثيره
، لم يحصل البرء لعدم المصادفة ، ومتى تمت المصادفة حصل البرء بإذن الله
ولا بد ، وهذا أحسن المحملين في الحديث .
والثاني : أن يكون من العام المراد به الخاص ، لا سيما والداخل في اللفظ
أضعاف أضعاف الخارج منه ، وهذا يستعمل في كل لسان ، ويكون المراد أن الله
لم يضع داء يقبل الدواء إلا وضع له دواء ، فلا يدخل في هذا الأدواء التي
لا تقبل الدواء ، وهذا كقوله تعالى في الريح التي سلطها على قوم عاد : "
تدمر كل شيء بأمر ربها " [ الأحقاف : 25 ] أي كل شئ يقبل التدمير ، ومن
شأن الريح أن تدمره ، ونظائره كثيرة .
ومن تأمل خلق الأضداد في هذا العالم ، ومقاومة بعضها لبعض ، ودفع بعضها
ببعض ، وتسليط بعضها على بعض ، تبين له كمال قدرة الرب تعالى ، وحكمته ،
وإتقانه ما صنعه ، وتفرده بالربوبية ، والوحدانية ، والقهر ، وأن كل ما
سواه فله ما يضاده ويمانعه ، كما أنه الغني بذاته ، وكل ما سواه محتاج
بذاته .
وفي الأحاديث الصحيحة الأمر بالتداوي ، وأنه لا ينافي التوكل ، كما لا
ينافيه دفع داء الجوع ، والعطش ، والحر ، والبرد بأضدادها ، بل لا تتم
حقيقة التوحيد إلا بمباشرة الأسباب التي نصبها الله مقتضيات لمسبباتها
قدراً وشرعاً ، وأن تعطيلها يقدح في نفس التوكل ، كما يقدح في الأمر
والحكمة ، ويضعفه من حيث يظن معطلها أن تركها أقوى في التوكل ، فإن تركها
عجزاً ينافي التوكل الذي حقيقته اعتماد القلب على الله في حصول ما ينفع
العبد في دينه ودنياه ، ودفع ما يضره في دينه ودنياه ، ولا بد مع هذا
الإعتماد من مباشرة الأسباب ، وإلا كان معطلاً للحكمة والشرع ، فلا يجعل
العبد عجزه توكلاً ، ولا توكله عجزاً .
وفيها رد على من أنكر التداوي ، وقال : إن كان الشفاء قد قدر ، فالتداوي
لا يفيد ، وإن لم يكن قد قدر ، فكذلك . وأيضاً ، فإن المرض حصل بقدر الله
، وقدر الله لا يدفع ولا يرد ، وهذا السؤال هو الذي أورده الأعراب على
رسول الله صلى الله عليه وسلم . وأما أفاضل الصحابة ، فأعلم بالله وحكمته
وصفاته من أن يوردوا مثل هذا ، وقد أجابهم النبي صلى الله عليه وسلم بما
شفى وكفى ، فقال : هذه الأدوية والرقى والتقى هي من قدر الله ، فما خرج شئ
عن قدره ، بل يرد قدره بقدره ، وهذا الرد من قدره ، فلا سبيل إلى الخروج
عن قدره بوجه ما ، وهذا كرد قدر الجوع ، والعطش والحر ، والبرد بأضدادها ،
وكرد قدر العدو بالجهاد وكل من قدر الله : الدافع ، والمدفوع والدفع .
ويقال لمورد هذا السؤال : هذا يوجب عليك أن لا تباشر سبباً من الأسباب
التي تجلب بها منفعة ، أو تدفع بها مضرة ، لأن المنفعة والمضرة إن قدرتا ،
لم يكن بد من وقوعهما ، وإن لم تقدرا لم يكن سبيل إلى وقوعهما ، وفي ذلك
خراب الدين والدنيا ، وفساد العالم ، وهذا لا يقوله إلا دافع للحق ، معاند
له ، فيذكر القدر ليدفع حجة المحق عليه ، كالمشركين الذين قالوا : " لو
شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا " [ الأنعام : 148 ] ، و " لو شاء الله ما
عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا " [ النحل : 35 ] ، فهذا قالوه دفعاً
لحجة الله عليهم بالرسل .
وجواب هذا السائل أن يقال : بقي قسم ثالث لم تذكره ، هو أن الله قدر كذا
وكذا بهذا السبب ، فإن أتيت بالسبب حصل المسبب ، وإلا فلا ، فإن قال : إن
كان قدر لي السبب ، فعلته ، وإن لم يقدره لي لم أتمكن من فعله .
قيل : فهل تقبل هذا الإحتجاج من عبدك ، وولدك ، وأجيرك إذا احتج به عليك
فيما أمرته به ، ونهيته عنه فخالفك ؟ فإن قبلته ، فلا تلم من عصاك ، وأخذ
مالك ، وقذف عرضك ، وضيع حقوقك ، وإن لم تقبله ، فكيف يكون مقبولاً منك في
دفع حقوق الله عليك. وقد روي في أثر إسرائيلي : أن إبراهيم الخليل قال :
يا رب ممن الداء ؟ قال : مني . قال : فممن الدواء ؟ قال : مني. قال : فما
بال الطبيب ؟ . قال : رجل أرسل الدواء على يديه .
وفي قوله صلى الله عليه وسلم : " لكل داء دواء" ، تقوية لنفس المريض
والطبيب ، وحث على طلب ذلك الدواء والتفتيش عليه ، فإن المريض إذا استشعرت
نفسه أن لدائه دواء يزيله ، تعلق قلبه بروح الرجاء ، وبردت عنده حرارة
اليأس ، وانفتح له باب الرجاء ، ومتى قويت نفسه انبعثت حرارته الغريزية ،
وكان ذلك سببها لقوة الأرواح الحيوانية والنفسانية والطبيعية ، ومتى قويت
هذه الأرواح ، قويت القوى التي هي حاملة لها ، فقهرت المرض ودفعته .
وكذلك الطبيب إذا علم أن لهذا الداء دواء أمكنه طلبه والتفتيش عليه .
وأمراض الأبدان على وزان أمراض القلوب ، وما جعل الله للقلب مرضاً إلا جعل
له شفاء بضده ، فإن علمه صاحب الداء واستعمله ، وصادف داء قلبه ، أبرأه
بإذن الله تعالى .
فصل
في هديه صلى الله عليه وسلم في الإحتماء من التخم ، والزيادة في الأكل على قدر الحاجة ، والقانون الذي ينبغي مراعاته في الأكل والشرب
في المسند وغيره : عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : " ما ملأ آدمي وعاءً
شراً من بطن ، بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه ، فإن كان لا بد فاعلاً ،
فثلث لطعامه ، وثلث لشرابه ، وثلث لنفسه " .
الأمراض نوعان : أمراض مادية تكون عن زيادة مادة أفرطت في البدن حتى أضرت
بأفعاله الطبيعية ، وهي الأمراض الأكثرية ، وسببها إدخال الطعام على البدن
قبل هضم الأول ، والزيادة في القدر الذي يحتاج إليه البدن ، وتناول
الأغذية القليلة النفع ، البطيئة الهضم ، والإكثار من الأغذية المختلفة
التراكيب المتنوعة ، فإذا ملأ الآدمي بطنه من هذه الأغذية ، واعتاد ذلك ،
أورثته أمراضاً متنوعة ، منها بطيء الزوال وسريعه ، فإذا توسط في الغذاء ،
وتناول منه قدر الحاجة ، وكان معتدلاً في كميته وكيفيته، كان انتفاع البدن
به أكثر من انتفاعه بالغذاء الكثير .
ومراتب الغذاء ثلاثة : أحدها : مرتبة الحاجة . والثانية : مرتبة الكفاية .
والثالثة : مرتبة الفضلة . فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم : أنه يكفيه
لقيمات يقمن صلبه ، فلا تسقط قوته ، ولا تضف معها ، فإن تجاوزها ، فليأكل
في ثلث بطنه ، ويدع الثلث الآخر للماء ، والثالث للنفس ، وهذا من أنفع ما
للبدن والقلب ، فإن البطن إذا امتلأ من الطعام ضاق عن الشراب ، فإذا ورد
عليه الشراب ضاق عن النفس ، وعرض له الكرب والتعب بحمله بمنزلة حامل الحمل
الثقيل ، هذا إلى ما يلزم ذلك من فساد القلب ، وكسل الجوارح عن الطاعات ،
وتحركها في الشهوات التي يستلزمها الشبع . فامتلاء البطن من الطعام مضر
للقلب والبدن .
هذا إذا كان دائماً أو أكثرياً . وأما إذا كان في الأحيان ، فلا بأس به ،
فقد شرب أبو هريرة بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم من اللبن ، حتى قال :
والذي بعثك بالحق ، لا أجد له مسلكاً . وأكل الصحابة بحضرته مراراً حتى
شبعوا .
والشبع المفرط يضعف القوى والبدن ، وإن أخصبه ، وإنما يقوى البدن بحسب ما يقبل من الغذاء ، لا بحسب كثرته .
ولما كان في الإنسان جزء أرضي ، وجزء هوائي ، وجزء مائي ، قسم النبي صلى الله عليه وسلم طعامه وشرابه ونفسه على الأجزاء الثلاثة .
فإن قيل : فأين حظ الجزء الناري ؟
قيل : هذه مسألة تكلم فيها الأطباء ، وقالوا : إن في البدن جزءاً نارياً بالفعل ، وهو أحد أركانه واسطقساته .
ونازعهم في ذلك آخرون من العقلاء من الأطباء وغيرهم ، وقالوا : ليس في البدن جزء ناري بالفعل ، واستدلوا بوجوه :
أحدها : أن ذلك الجزء الناري إما أن يدعى أنه نزل عن الأثير ، واختلط بهذه
الأجزاء المائية والأرضية ، أو يقال : إنه تولد فيها وتكون ، والأول
مستبعد لوجهين ، أحدهما : أن النار بالطبع صاعدة ، فلو نزلت ، لكانت بقاسر
من مركزها إلى هذا العالم . الثاني : أن تلك الأجزاء النارية لا بد في
نزولها أن تعبر على كرة الزمهرير التي هي في غاية البرد ، ونحن نشاهد في
هذا العالم أن النار العظيمة تنطفئ بالماء القليل ، فتلك الأجزاء الصغيرة
عند مرورها بكرة الزمهرير التي هي في غاية البرد ، ونهاية العظم أولى
بالانطفاء .
وأما الثاني : - وهو أن يقال : إنها تكونت ها هنا - فهو أبعد وأبعد ، لأن
الجسم الذي صار ناراً بعد أن لم يكن كذلك ، قد كان قبل صيرورته إما أرضاً
، وإما ماء ، وإما هواء لانحصار الأركان في هذه الأربعة ، وهذا الذي قد
صار ناراً أولاً ، كان مختلطاً بأحد هذه الأجسام ، ومتصلاً بها ، والجسم
الذي لا يكون ناراً إذا اختلط بأجسام عظيمة ليست بنار ولا واحد منها ، لا
يكون مستعداً لأن ينقلب ناراً لأنه في نفسه ليس بنار ، والأجسام المختلطة
باردة ، فكيف يكون مستعداً لانقلابه ناراً ؟
فإن قلتم : لم لا تكون هناك أجزاء نارية تقلب هذه الأجسام ، وتجعلها ناراً بسبب مخالطتها إياها ؟
قلنا : الكلام في حصول تلك الأجزاء النارية كالكلام في الأول ، فإن قلتم :
إنا نرى من رش الماء على النورة المطفأة تنفصل منها نار ، وإذا وقع شعاع
الشمس على البلورة ، ظهرت النار منها ، وإذا ضربنا الحجر على الحديد ،
ظهرت النار ، وكل هذه النارية حدثت عند الإختلاط ، وذلك يبطل ما قررتموه
في القسم الأول أيضاً .
قال المنكرون : نحن لا ننكر أن تكون المصاكة الشديدة محدثة للنار ، كما في
ضرب الحجارة على الحديد ، أو تكون قوة تسخين الشمس محدثة للنار ، كما في
البلورة ، لكنا نستبعد ذلك جداً في أجرام النبات والحيوان ، إذ ليس في
أجرامها من الإصطكاك ما يوجب حدوث النار ، ولا فيها من الصفاء والصقال ما
يبلغ إلى حد البلورة ، كيف وشعاع الشمس يقع على ظاهرها ، فلا تتولد النار
البتة ، فالشعاع الذي يصل إلى باطنها كيف يولد النار ؟
الوجه الثاني : في أصل المسألة : أن الأطباء مجمعون على أن الشراب العتيق
في غاية السخونة بالطبع ، فلو كانت تلك السخونة بسبب الأجزاء النارية ،
لكانت محالاً إذ تلك الأجزاء النارية مع حقارتها كيف يعقل بقاؤها في
الأجزاء المائية الغالبة دهراً طويلاً ، بحيث لا تنطفئ مع أنا نرى النار
العظيمة تطفأ بالماء القليل .
الوجه الثالث : أنه لو كان في الحيوان والنبات جزء ناري بالفعل ، لكان
مغلوباً بالجزء المائي الذي فيه ، وكان الجزء الناري مقهوراً به ، وغلبة
بعض الطبائع والعناصر على بعض يقتضي انقلاب طبيعة المغلوب إلى طبيعة
الغالب ، فكان يلزم بالضرورة انقلاب تلك الأجزاء النارية القليلة جداً إلى
طبيعة الماء الذي هو ضد النار
الوجه الرابع : أن الله سبحانه وتعالى ذكر خلق الإنسان في كتابه في مواضع
متعددة ، يخبر في بعضها أنه خلقه من ماء ، وفي بعضها أنه خلقه من تراب ،
وفي بعضها أنه خلقه من المركب منهما وهو الطين ، وفي بعضها أنه خلقه من
صلصال كالفخار ، وهو الطين الذي ضربته الشمس والريح حتى صار صلصالاً
كالفخار ، ولم يخبر في موضع واحد أنه خلقه من نار ، بل جعل ذلك خاصية
إبليس . وثبت في صحيح مسلم : عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " خلقت
الملائكة من نور ، وخلق الجان من مارج من نار ، وخلق آدم مما وصف لكم " ،
وهذا صريح في أنه خلق مما وصفه الله في كتابه فقط ، ولم يصف لنا سبحانه
أنه خلقه من نار ، ولا أن في مادته شيئاً من النار .
الوجه الخامس : أن غاية ما يستدلون به ما يشاهدون من الحرارة في أبدان
الحيوان ، وهي دليل على الأجزاء النارية ، وهذا لا يدل ، فإن أسباب
الحرارة أعم من النار ، فإنها تكون عن النار تارة ، وعن الحركة أخرى ، وعن
انعكاس الأشعة ، وعن سخونة الهواء ، وعن مجاورة النار ، وذلك بواسطة سخونة
الهواء أيضاً ، وتكون عن أسباب أخر ، فلا يلزم من الحرارة النار .
قال أصحاب النار : من المعلوم أن التراب والماء إذا اختلطا فلا بد لهما من
حرارة تقتضي طبخهما وامتزاجهما ، وإلا كان كل منهما غير ممازج للآخر ، ولا
متحداً به ، وكذلك إذا ألقينا البذر في الطين بحيث لا يصل إليه الهواء ولا
الشمس فسد ، فلا يخلو ، إما أن يحصل في المركب جسم منضج طابخ بالطبع أو لا
، فإن حصل ، فهو الجزء الناري ، وإن لم يحصل ، لم يكن المركب مسخناً بطبعه
، بل إن سخن كان التسخين عرضياً ، فإذا زال التسخين العرضي ، لم يكن الشيء
حاراً في طبعه ، ولا في كيفيته ، وكان بارداً مطلقاً ، لكن من الأغذية
والأدوية ما يكون حاراً بالطبع ، فعلمنا أن حرارتها إنما كانت ، لأن فيها
جوهراً نارياً .
وأيضاً فلو لم يكن في البدن جزء مسخن لوجب أن يكون في نهاية البرد ، لأن
الطبيعة إذا كانت مقتضية للبرد ، وكانت خالية عن المعاون والمعارض ، وجب
انتهاء البرد إلى أقصى الغاية ، ولو كان كذلك لما حصل لها الإحساس بالبرد
، لأن البرد الواصل إليه إذا كان في الغاية كان مثله ، والشئ لا ينفعل عن
مثله ، وإذا لم ينفعل عنه لم يحس به ، وإذا لم يحس به لم يتألم عنه ، وإن
كان دونه فعدم الإنفعال يكون أولى ، فلو لم يكن في البدن جزء مسخن بالطبع
لما انفعل عن البرد ، ولا تألم به . قالوا : وأدلتكم إنما تبطل قول من
يقول : الأجزاء النارية باقية في هذه المركبات على حالها ، وطبيعتها
النارية ، ونحن لا نقول بذلك ، بل نقول : إن صورتها النوعية تفسد عند
الإمتزاج .
قال الآخرون : لم لا يجوز أن يقال : إن الأرض والماء والهواء إذا اختلطت ،
فالحرارة المنضجة الطابخة لها هي حرارة الشمس وسائر الكواكب ، ثم ذلك
المركب عند كمال نضجه مستعد لقبول الهيئة التركيبية بواسطة السخونة نباتاً
كان أو حيواناً أو معدناً ، وما المانع أن تلك السخونة والحرارة التي في
المركبات هي بسبب خواص وقوى يحدثها الله تعالى عند ذلك الإمتزاج لا من
أجزاء نارية بالفعل ؟ ولا سبيل لكم إلى إبطال هذا الإمكان البتة ، وقد
اعترف جماعة من فضلاء الأطباء بذلك .
وأما حديث إحساس البدن بالبرد ، فنقول : هذا يدل على أن في البدن حرارة
وتسخيناً ، ومن ينكر ذلك ؟ لكن ما الدليل على انحصار المسخن في النار ،
فإنه وإن كان كل نار مسخناً ، فإن هذه القضية لا تنعكس كلية ، بل عكسها
الصادق بعض المسخن نار .
وأما قولكم بفساد صورة النار النوعية ، فأكثر الأطباء على بقاء صورتها
النوعية ، والقول بفسادها قول فاسد قد اعترف بفساده أفضل متأخريكم في
كتابه المسمى بالشفا ، وبرهن على بقاء الأركان أجمع على طبائعها في
المركبات . وبالله التوفيق .
فصل
وكان علاجه صلى الله عليه وسلم للمرض ثلاثة أنواع . . .
أحدها : بالأدوية الطبيعية .
والثاني : بالأدوية الإلهية .
والثالث : بالمركب من الأمرين .
ونحن نذكر الأنواع الثلاثة من هديه صلى الله عليه وسلم ، فنبدأ بذكر
الأدوية الطبيعية التي وصفها واستعملها ، ثم نذكر الأدوية الإلهية ، ثم
المركبة .
وهذا إنما نشير إليه إشارة ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعث
هادياً ، وداعياً إلى الله ، وإلى جنته ، ومعرفاً بالله ، ومبيناً للأمة
مواقع رضاه وآمراً لهم بها ، ومواقع سخطه وناهياً لهم عنها ، ومخبرهم
أخبار الأنبياء والرسل وأحوالهم مع أممهم ،
وأخبار تخليق العالم ، وأمر المبدأ والمعاد ، وكيفية شقاوة النفوس وسعادتها ، وأسباب ذلك .
وأما طب الأبدان : فجاء من تكميل شريعته ، ومقصوداً لغيره ، بحيث إنما
يستعمل عند الحاجة إليه ، فإذا قدر على الإستغناء عنه، كان صرف الهمم
والقوى إلى علاج القلوب والأرواح ، وحفظ صحتها ، ودفع أسقامها ، وحميتها
مما يفسدها هو المقصود بالقصد الأول ، وإصلاح البدن بدون إصلاح القلب لا
ينفع ، وفساد البدن مع إصلاح القلب مضرته يسيرة جداً ، وهي مضرة زائلة
تعقبها المنفعة الدائمة التامة ، وبالله التوفيق .